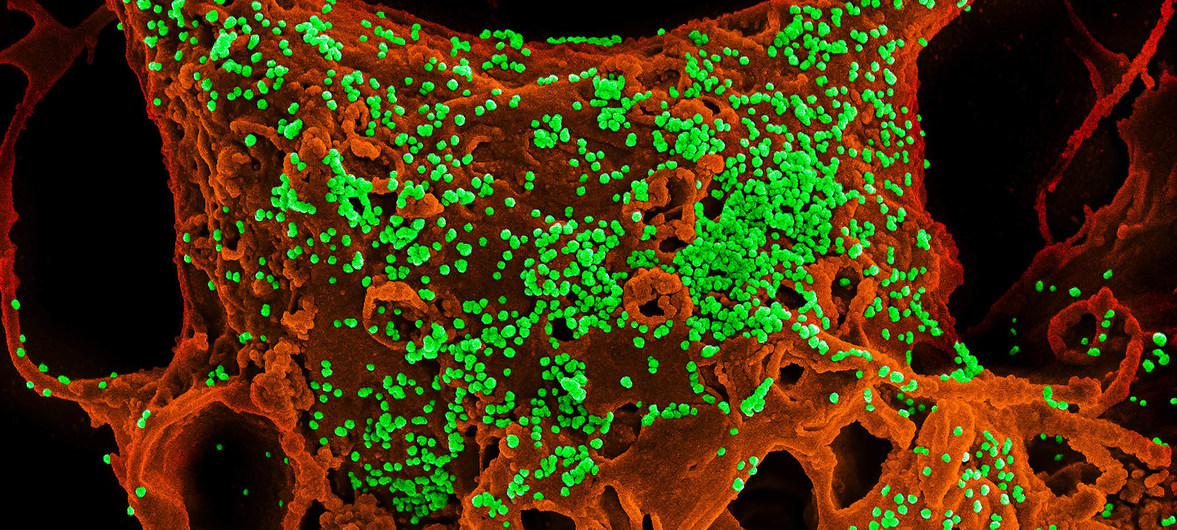أيهما أسهل بالنسبة لك في الوصف: لون العشب أم رائحته؟ ربما تعتمد إجابتك على هذا السؤال على موطنك، وبالتحديد أكثر على اللغة التي كبرت ونشأت وهي تجري على لسانك.
على أي حال، يُصنف البشر في غالبية الأحيان على أنهم كائناتٌ بصرية. وربما تتفق مع ذلك دون تفكير إذا كانت الإنجليزية هي لغتك الأم، فهي لغةٌ ثريةٌ بمفرداتها المتعلقة بالألوان والأشكال الهندسية، لكنها لا تتضمن سوى مفرداتٍ محدودة لوصف الروائح.
ورغم ذلك، أشارت دراسةٌ أُجريت مؤخراً على مستوى العالم إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين الثقافات فيما يتعلق بالحاسة الرئيسية التي يكتسب كلٌ منّا من خلالها خبراته عن العالم؛ وما إذا كان هذا الأمر يحدث من خلال الرؤية أو السمع أو الشم أو التذوق أو الشعور. وأفادت الدراسة بأن تفضيل هذه الحاسة أو تلك عن غيرها ينعكس على اللغة التي نتحدث بها.
واستندت الدراسة إلى تجارب أُجراها 26 باحثاً على الناطقين بعشرين لغةً في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وأستراليا. وتنوعت المناطق التي جاء منها أفراد العينة بين مدنٍ كبيرةٍ عصرية وقرى نائيةٍ يقطنها أبناء البلاد الأصليون.
وقد طُلب من المشاركين في التجربة وصف ما يُعرف بـ "المنبهات الحسية" من قبيل قطعٍ من الورق الملون، أو رشفات من الماء المُحلى بالسكر، أو الإقدام على شم بطاقة مُعطرة.
وأشارت النتائج إلى أن التصورات التي نكوّنها عن الأشياء، يمكن أن تتأثر بعوامل من قبيل نمط حياتنا والبيئة التي نعيش فيها، بل وحتى الأشكال التي تتخذها منازلنا. ومن بين هذه العوامل كذلك، مدى صعوبة أو سهولة عثورنا على مفرداتٍ يمكن لنا من خلالها ترجمة هذه التصورات على شكل كلمات.
وقادت أصيفة ماجد، أستاذة اللغة والتواصل والإدراك الثقافي في جامعة يورك البريطانية، فريق البحث الذي أجرى الدراسة، وتقول: "أعتقد أننا غالباً ما نرى أن اللغة تمنحنا معلوماتٍ مباشرةً عن العالم. بوسعك أن ترى ذلك جلياً في الطريقة التي نفكر فيها بشأن الحواس، وكيف ينعكس ذلك على العلوم الحديثة".
وتضيف أن الكثير من الكتب المدرسية - على سبيل المثال - تشير إلى البشر باعتبارهم مخلوقاتٍ تعتمد على الرؤية البصرية.
وتشير ماجد إلى أن جانبا من الأساس المنطقي لهذا الوصف أو التصور يرتبط بالمساحة المُخصصة للرؤية في الدماغ مُقارنةً بنظيرتها المسؤولة عن الشم مثلاً.
بيد أنها تشير إلى أن اللغة تشكل أحد العوامل المهمة في هذا الشأن أيضاً، وأن هذا هو السبب الذي يجعل لدى الناس الكثير والكثير من المفردات التي يمكنهم استخدامها للحديث عما يرونه، بينما يعانون الأمرين للتحدث عن الأشياء التي يشمون رائحتها.
 مصدر الصورةBBC/GETTY
مصدر الصورةBBC/GETTY
غير أن أصيفة ماجد تقول إن هناك مجتمعاتٍ تكون أكثر اهتماماً وارتباطاً من غيرها بالروائح أو الأصوات. ففي الدراسة التي أجرتها عن تجمعٍ سكانيٍ يعيش أفراده اعتماداً على الصيد وجمع الثمار في شبه جزيرة الملايو ويحمل اسم "جاهاي"، سجلت مفرداتٍ تتعلق بالروائح مماثلةً في تنوعها ودقتها للكلمات التي تزخر بها اللغة الإنجليزية للحديث عن الألوان.
وجمعت الدراسة خبراء في لغاتٍ متنوعةٍ ومختلفةٍ على نحو كبيرٍ، إلى حد أن قائمتها تشمل لغةً مثل أمبايلا التي لا يتحدث بها سوى مئة شخص تقريباً في أستراليا، وكذلك الإنجليزية التي يبلغ عدد الناطقين بها نحو مليار نسمة في شتى أنحاء العالم.
وفي إطار التجربة، منح الباحثون أفراد العينة - الذين بلغ عددهم الإجمالي 313 - المحفزات المختلفة للحواس، ثم عكفوا على قياس مستوى التوافق الذي شهدته كل مجموعةٍ، على صعيد الاستجابات الصادرة من جانب أفرادها.
ويعني وجود مستوى مرتفعٍ من هذا التوافق في مجموعةٍ ما، أن لدى أفراد هذه المجموعة طريقةً متفقٌ عليها للحديث - مثلاً - عن ألوانٍ بعينها. أما تدني هذا المستوى فمن شأنه الإشارة إلى أن تلك المجموعة تفتقر إلى مفرداتٍ مشتركةٍ ومقبولةٍ بوجهٍ عام للحديث عن هذه الألوان، أو أن أفرادها غير قادرين على تحديدها والتعرف عليها من الأصل.
وكشفت الدراسة عن أن الناطقين بالإنجليزية كانوا الأفضل على صعيد الحديث عن الأشكال والألوان. فقد اتفقوا جميعاً - على سبيل المثال - على أن شيئاً ما كان عبارةً عن مثلثٍ أو أن لون شيء آخر كان أخضر.
على الجانب الآخر، برع الناطقون باللغة الفارسية ولغة لاو - وهي اللغة الرسمية في لاوس - في وصف الطعم. فعندما أُعطوا مياهاً يشوبها مذاقٌ مر، وصفها كل الناطقين بالفارسية بكلمة "تلخ"، وهي المفردة التي تعبر عن كلمة "مر" باللغة الفارسية.
لكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لمن يتحدثون الإنجليزية. فعندما تم اعطاؤهم المياه ذاتها، تعددت كثيراً - كما تقول أصيفة ماجد - المسميات التي استخدموها لوصفها؛ من "مرة" إلى "مالحة" إلى "حامضة" إلى "ليست سيئة" إلى "عادية" إلى "إنها بطعم النعناع" إلى "إنها مثل شمع الأذن" إلى "إنها ذات مذاقٍ يشبه الدواء"، وما إلى ذلك.
 مصدر الصورةBBC/GETTY
مصدر الصورةBBC/GETTY
وتقول ماجد إن هذا النوع من الارتباك في تحديد الطعم والنكهات المختلفة يحدث باستمرار للناطقين بالإنجليزية في التجارب المعملية. وتشير إلى أن هؤلاء "يصفون الطعم المر بأنه مالحٌ وحامضٌ، ويصفون الطعم الحامض بأنه مرٌ، كما يصفون المالح بأنه حامض. لذا فحتى إذا كانت لدينا المفردات اللازمة لوصف شيءٍ ما، يبدو أن هناك قدراً من الارتباك في أذهان الناس بشأن كيف يمكنهم الربط بين تجربة التذوق التي مروا بها والمفردات اللغوية الموجودة لديهم".
ومن المثير للاهتمام، أن كل التجمعات اللغوية التي أحرز أفرادها درجاتٍ عاليةً في اختبار التذوق هذا، والتي تتحدث الفارسية ولغة لاو واللغة الكانتونية - وهي أحد الفروع الرئيسية للصينية - تشتهر بأن لديها مدارس متطورةً ومعقدةً في الطهي تستخدم مجموعةً متنوعةً وواسعةً من النكهات، بما في ذلك ذات الطعم المر منها.
وقد واجه مبحوثون آخرون مشقةً كذلك في أداء مهام بعينها، لأن اللغة التي يتحدثون بها تفتقر ببساطة للمفردات التي تُمَكِنُهم من التعبير عما يُعرض عليهم خلال هذه المهام. فالناطقون بلغة "أمابيلا" - التي يتحدثها تجمعٌ سكانيٌ يعيش كما قلنا سلفاً في أستراليا ويقتات أهله على الصيد وجمع الثمار - ليس لديهم من الأصل سوى مفرداتٍ تصف ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر. لكن المتحدثين بهذه اللغة يجدون أنه من الأسهل بالنسبة لهم أن يصفوا الروائح التي يشمونها.
وتوجد هذه النزعة التي تولي الاهتمام للشم لا للرؤية، لدى التجمعات التي تضم من يعتمدون على الصيد وجمع الثمار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تجمع "جاهاي" المذكور آنفاً. وربما كان السبب في ذلك يعود إلى أن أفراد تلك التجمعات يعيشون ويمارسون الصيد في الغابات، وهي بقاعٌ غنية بالروائح المتنوعة.
 مصدر الصورةBBC/GETTY
مصدر الصورةBBC/GETTY
اللافت أن التنوع والاختلاف القائمين بين البشر على صعيد الاهتمام الذي يولونه لهذه الحاسة أو تلك وعلاقة ذلك باللغة التي يتحدثون بها، موجودان كذلك حتى بين مستخدمي لغة الإشارة. فمن يستخدمون لغة إشارةٍ تُعرف باسم "كاتا كولوك" - ممن يبلغ عددهم نحو 1200 شخص يعيشون في جزيرة بالي الإندونيسية - يواجهون المعاناة نفسها تقريباً التي يلاقيها الناطقون بلغة أمبايلا في الحديث عن الألوان ووصفها.
في المقابل، كان أداء هذه المهمة يسيراً نسبياً على مستخدمي لغتي الإشارة الأمريكية والبريطانية، الذين حصلوا على درجاتٍ تقارب تلك التي حصل عليها الناطقون بالإنجليزية على الصعيد ذاته.
وفي الوقت نفسه، بدا أنه كان للعوامل الثقافية التي ترتبط بأشياء تتراوح ما بين الفنون والهندسة المعمارية، دورٌ في تحديد المستوى الذي أبداه أفراد العينة في التعامل مع الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها. فمن قَدِموا من مجتمعات تُنتج الفخار المزخرف - على سبيل المثال - أدوا بشكلٍ أفضل في الاختبارات المتعلقة بالحديث عن الأشكال.
كما أن من يعيشون في منازل ذات أركانٍ وزوايا متعددة، كانوا أكثر قدرة على وصف الأشكال ذات الزوايا بدورها، مُقارنةً بأقرانهم القاطنين في بيوتٍ تتخذ شكلاً دائرياً على نحوٍ أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن القادمين من مجتمعاتٍ يوجد فيها موسيقيون بارعون، كانوا أكثر قدرة على وصف الأصوات، حتى رغم أنهم لم يكونوا موسيقيين هم أنفسهم.
وتقول أصيفة ماجد: "إن مجرد وجود موسيقيين بارعين في مجتمعٍ ما، يعني أن هذا المجتمع طوّر طريقةً معينةً للحديث عن الأصوات، وأن لكل فردٍ فيه وسيلة أفضل - على ما يبدو - فيما يتعلق بهذا الأمر".
 مصدر الصورةBBC/GETTY
مصدر الصورةBBC/GETTY
وبالنسبة لمن يقضون منّا الجانب الأكبر من وقتهم أمام شاشاتٍ صامتةٍ عديمة الرائحة بدلاً من قضاء هذا الوقت بين النباتات الفواحة بالروائح والموسيقيين، ربما تشكل هذه الدراسة مصدر تشجيعٍ لهم لكي يعملوا على استكشاف واكتساب خبراتٍ حسيةٍ جديدة. كما تمثل في الوقت نفسه تذكيراً بقيمة التنوع اللغوي.
فرغم أن لغة "أمبايلا" - على سبيل المثال - مهددةٌ بالانقراض وعدد الناطقين بها كلغةٍ أم يتضاءل، فإننا عندما نتحدث عن الروائح وتفاوت ثراء اللغات المختلفة بشأن وصفها والحديث عنها؛ نجد أن هذه اللغة النادرة التي تكتنفها المخاطر، تفوق على ما يبدو لغةً مزدهرةً كالإنجليزية يبلغ عدد المتحدثين بها قرابة المليار شخص.