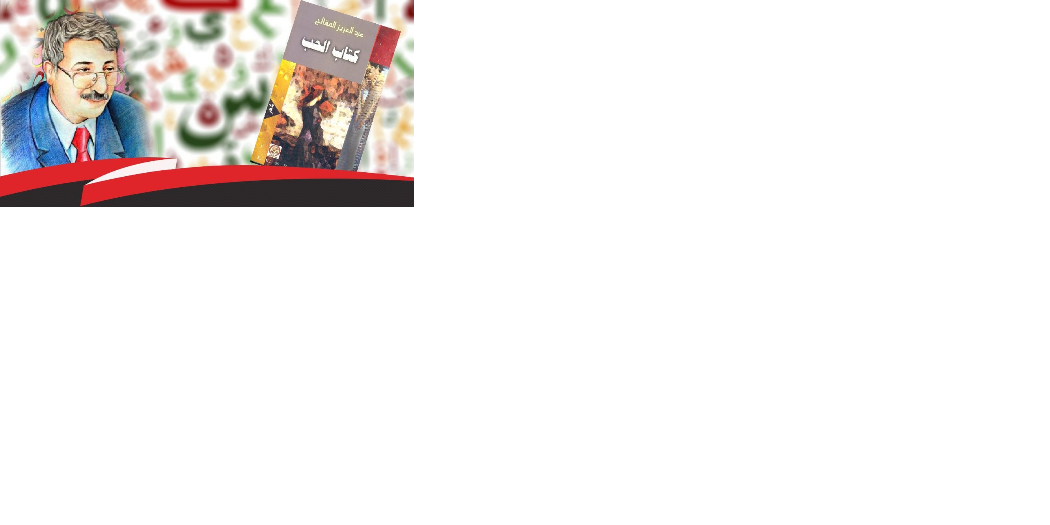محمد جازم
“سلام هو الحب
حين تدق الحروب
الطبول
ويركب أهل الشقاق خيول حماقاتِهم
تلبس المدن الثاكلات ثياب الدماء
ويرتدي الأبرياء الأجلاء
أكفانهم
ثم لا يجدون ملاذاً لأطفالهم
غير أن يمسكوا بالنهار
الذي يتلألأ في ملكوت المحبة” (ص32)
كُتبت قصائد هذا الديوان عبر عقود من الزمن، ابتداء بالسبعينيات وانتهاء بالعام 2012.
وأجرى الشاعر على قصائد الديوان بعض التعديلات، حسب مقدمته، وتحديداً بداية التسعينيات؛ فقد عزم حينها على إصدار الديوان، إلا أنه عاد وتناسى نصوصه؛ إلى أن عزم على إصداره عند نشوء الازمة اليمنية، ولعله أراد تذكيرنا بأن الحب هو طريق البناء، وليس الحرب، حيث كُتب لنا أن نرى إشراقاته وأنواره.
يمكننا أن نقول بداية إننا في هذا الديوان الذي صدر عن مؤسسة أروقة للترجمة والدراسات والنشر، عام 2014، وجدنا سيرة شعرية للشاعر عبدالعزيز المقالح، وتمرد كثيراً على التابو، واحتفى كثيراً بالعواطف الحقيقية التي لا يلتبس فيها الخيالي بالواقعي، وإنما يرتفع فيها الشعر إلى الصدق الحكائي؛ فتحس وأنت تقرأ القصائد كما لو أنك تحتفي بقصة حدثت للشاعر حقاً، وليست من وحي الخيال كما اعتدنا في الكتابة الشعرية. كل نص هنا نستطيع أن نسوغ له سيناريو من وحي التصاعد الدراماتيكي للحدث الشعري، وهو ما يمكن قراءته في معظم نصوص الديوان.
أراد الشاعر -أيضاً- أن يخبر قارئه عن أودية مشاعر المحبة التي نضبت، وتلك التي جفّت عيونها، على الرغم من موروث العشق الهائل الذي نضحت به كٌتب الأدب العربي شعراً ونثراً، وقد تنبه إلى أن عصرنا هذا الموصوم بالتكنولوجيا والميديا والأجهزة العملاقة والدقيقة، تسارعت فيه وتيرة المعرفة الخالية من الروح، فتعاملاتنا كلها تتم عبر أجهزة صماء بكماء، وبالتالي فالضرورة قائمة.. أما وأن الحب قد أصبح عٌملة نادرة التداول؛ فإن كتاب الحب لا بد أن يصل إلى الناس، لا بد أن نذهب معه إلى أبعد مدى… إلى رفوف الأكشاك وأبواب الفنادق، وأسطح المنازل… لا بد أن نعلقه على سيقان الأشجار ومواسير الدبابات، وأعقاب البنادق، وطاولات الثّكن العسكرية، لعل ثماره تؤتي أكلها… على الأقل هنا في هذه الأصقاع المدججة بالبارود، التي يوجهها بقوله:
“حامضة هي الأيام/ مرة هي الساعات/ معتم هو الحاضر والآتي/ في أزمنة اللاحب/ لا مكان للربيع/ لا مكان للأزهار/ لا مكان للأغاني” (ص154).
الأفكار والرؤى الشعرية
إن رؤية الديوان وموضوعاته وأفكاره متعددة بتعدد تجارب الشاعر التي تستشرف المستقبل وتحاكيه. نجده يكتب سيرة الأشياء من حوله، كما يكتب سيرته الذاتية وسير الأصدقاء، وتشظي الحبيبات اللواتي ينقل إلينا حواراته المسرحية والفلسفية معهن، بحنكة العارف. ثمة وصايا وأسئلة، ورسائل حب واشتياقات ولواعج، وهناك اعترافات وأحزان وخلفيات موسيقية ووصفات علاجية أيضاً. هذه هي أدوات السيرة القريبة من الشعر الواقعي، البعيدة عن الخيال المبالغ في صنعه. تتداخل القصائد في الديوان مع الروايات والقصص القصيرة ولوحات الفن التشكيلي؛ فمثلاً هذه قصيدة “نساء” تستعرض وتسرد؛ وتؤرخ للحبيبات اللواتي عبرن في الذاكرة.
ذاكرة الشاعر التي ظلت مخلصة لتلك اللحظات البهية، إلى أن وجدت مكاناً لها في حدائق الشعر العربي؛ يقول:
“الأولى كانت البيت أمام البيت/الباب أمام الباب/ النافذتان المتواجهتان/ تضيئان زقاقاً ضاق بأطفال الجيران/ كانت تختلس الوقت المتبقي من يوم مكدود الأنفاس/ لتلقي نظرة خوف للشارع/ ثم تغذي روحي بالأخرى” (ص24).
وفي المقطع الثاني يقول:
“الثانية كانت أكبر مني/ تأتي للبيت لكي تتفرس في وجهي… الثالثة تهوى الشعر وترغب في أن تكتبه: قالت: علمني الشعر؛ فقلت أعلمك الحب” (ص26). وهكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي استقر شغفه على أمرها، وهو ما يشير إلى أن الشاعر يرصد سيرته الذاتية شعراً، فقد تزوج أخيراً، إذ يقول:
“كانت طيبة للغاية/ فاتنة للغاية/ في عينيها شيءٌ/ من حزن البشر المنذورين لخدمة أهل الأرض/ وفي الصدر رصيدٌ لا ينفد/ من حب الله وحب الإنسان/ لم يتردد قلبي أن يهواها/ قلت لأمي: الآن اخترتُ/ فقالت: نعم المرأة” (ص30).
الرهان وخلاصة التجربة
يراهن الشاعر في الديوان على أهمية الحب، بل على ضرورته القصوى. الضرورة التي تأتي على رأس قائمة متطلبات حياتنا هذه التي أصبحت تنتمي إلى عالم غابوي شديد التعقيد؛ ففي الوقت الذي انزلق فيه السياسيون إلى أتون حرب ضروس، انزلق شاعرنا إلى عالمه الساطع بالمحبة، المتلهف إلى مدن السلام، ولعل خلاصة ما أراد قوله في المقدمة، هو أنه طوال عمره يراهن على الحب، وكلما اشتدت ضراوة البارود والراجمات الحربية؛ ازداد تعلقاً بالمحبة، فأنّى للشاعر أن يلين أو يتزحزح من موقعه الملتحم بالحب. وفي المقطع الشعري الذي سأستشهد به بعد قليل، نجد أن شاعرنا قد عرف الكراهية، وخبر الحروب، ورأى سياط الجلادين، وبأم عينيه رأى النتاج الحتمي لنقيض المحبة، وهو إنما يرشدنا إلى الحب، لأنه ينطلق من تجربة شخصية عميقة؛ يقول في قصيدة “الحب والحرية”:
“الإنسان الخائف لا يعرف معنى الحب/ ولا يدرك معنى للورد/ ولا معنى للموسيقى/ قلب حجّره الخوف/ محاط بثعابين القمع/ وأدمته سياط الجلادين/ يظل غريباً عنه الحب/ فلا حب بلا حرية” (ص152).
بدت قصائد الديوان كأنها نقطة الارتكاز التي بحث عنها الشاعر طويلاً عبر مسيرة حياته، التي لم يجد فيها الكثير سوى هذا الحب؛ هذا النقل “الاعترافي” الأمين؛ حيث تكللت التجربة بديوان “كتاب الحب”؛ أي خلاصة الحكمة.. خلاصة التجربة.. يقول:
“جمال هو الحب/ يجعلني أرقب الكائنات/ بعينين طاهرتين/ وقلبٍ نقي/ يرى في الزهور غناء/ وفي الصخر ماء/ وفي الشجر المزدهي حين يخضر/صورة/ فاتنة/ أو قصيدة” (ص34).
القصائد بمفرداتها وأبنيتها القريبة والبعيدة، ليست سوى واحة للتأمل؛ فمثلاً لماذا قال الشاعر جمال هو الحب، ولم يقل جميل هو الحب؟ لأن الجمال مصدر والجميل اشتقاق.
الحب هنا ليس حباً عادياً، وقائله تَعرّف على مئات المحبين، وخبر آلاف العشاق؛ أولئك الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه هو.. الحب هنا مختلف يقول:
“أي حُب تُحدّث عنه/ وتلهب أسماعنا بحكاياته/ أنت لا تعرف الحب يا صاحبي/آه لو كنت تعرفه/ لكتمت مواجيده/ في حنايا الفؤاد” (ص42).
نوع آخر من الحب.. داخل التجربة -أيضاً- نفحة إيقاع صوفية؛ فالمحب لا يبوح بسره تماماً كما هي تجربة الشاعر؛ لكن الإنسان العادي، الذي يتحكم بأدائه المجتمع، لا يعرف ذلك، ولن يرقى إلى تلك اللحظة مادام يجهل شروطها. إنه الشجن الصوفي اللذيذ. القصيدة موقف ولحظة تحدٍّ طولها يمتد ليغطي العمر بأكمله، ويؤكد عليها حين يقول:
“كل من يعرف الحب أو يبتلى بمواجعه/ يتكتمه لا يبوح بأسراره/ وخفايا ارتعاشاته/ وحنين الحواس” (ص43).
حقاً في الموروث الصوفي يحدث ذلك كما هو عند كبار المتصوفة مثل الحلاج والسهروردي الذي قال ذات يوم:
“أبداً تحن إليكم الأرواحُ ووصالكم ريحانها والراحُ
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيد وصالكم ترتاحُ
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباحُ”
يعيش الشاعر ليكتشف الكون هذا الذي يراه ويحسه؛ وربما الكون الذي لا يراه، ولكنه يحسه في نفسه.
في كل مرة يظل الشاعر هو الأكثر قرباً من الغيب، بخاصة عندما تتملكه التجربة، ولعلنا سنلمس حقيقة شعورية معبأة بروح الحكمة في هذا المقطع:
“لو كان الحب امرأة واحدة/ في الشكل وفي اللون وفي اللهفة/ ملّ الناس الحب/ وما احتاج القلب إليه وما كتب الشعراء قصائدهم بدم القلب” (ص145).
وما يمكن إضافته هنا هو أن الشاعر كان على قدر كبير بالوعي الحداثوي المعتاد في مجمل تجربته التي نظّر لها كثيراً، وتمثل روحها في كل ما كتب، وقد رأينا كيف أصبحت المفاهيم الأيديولوجية والأبستمولوجية منصهرة في شعره المضيء الذي لم تستطع وسائط الميديا إقلاق سكينته؛ أو التأثير على وقاره وصفائه، وفي كل مرة أيضاً كان الحب يحميه ويحرسه، يقول:
“داويت جروحي
بالشهرة حيناً
والعمل المضني أحياناً
لكن جروحي اتسعت
وتشظى القلب
وأدركه ما يدرك قفراً مهجور
ولذا أشتاق إليه
إلى الحب” (ص71)
هذا هو ما نذهب إليه هنا من أن الديوان يفصح عن سيرة ذاتية تكاد تقول خذوني. يقول ولهيلم دلتي: “السيرة الذاتية أرقى أشكال بلورة فقه الحياة وفعلها”، فما بالنا إذا تمت سباكة هذه السيرة في قالب شعري، واصطبغت بالصدق الفني والوجداني.
هذه تجربة أخرى يعانقها الديوان بحفاوة؛ إنها تجربة السيرة الحسية التي أعني بها ممارسة الحب؛ يقول في قصيدة “رسالة إلى حبيب”:
“حين دنت واقترب الأريج/ من عرش المكان/ استيقظ الورد/ وأورقت شبابيك الطريق الناعسات/ ابتل وجه الصبح من هديل الضوء… من أي جنة وفوق أي غيمة أتت إليّ/ أيقظت ماء الحنين/ فوق سطح الليل غنت/ داعبت حلمي/ ونامت في سرير من مرايا” (ص87).
تكاد تكون قصائد الجنس وإيحاءاته في الديوان ظاهرة لونية؛ مشتعلة بالحنين؛ يقول في قصيدة جسد:
“جسد مشتعل/ مبتل بالنعمة/ يتماهى فيه الأبيض بالأحمر/ رجراج/ تضحك فيه النشوة والفتنة…” (ص93).
رسائل عاجلة
تجرأت وأنا أقرأ الديوان فقلت: لو قدر لي أن أعيد ترتيب الديوان -كما لو كنت راوياً- لوضعت القصائد التالية تحت باب “رسائل عاجلة جداً…”، والقصائد هي: “رسالة- خمس رسائل إلى الحب- وصايا ثمينة من أم لا تكره الحب- رسالة إلى حبيب- إلى زميل- إلى سيدة- تحية، وكذلك قصيدة شكراً، ثم قصيدة نساء، لأنها تتضمن إيصال رسالة أيضاً”. بالغت في جرأتي فوضعت عنواناً آخر لبقية القصائد، وهو: إيقاعات؛ على اعتبار تعدد موضوعات القصائد وتنوع أخيلتها وصورها.. وبعد تفكير تراجعت عن صلفي؛ فقصائد الديوان كلها تتجاوز الرسائل والإيقاعات، ثم عدت فحدثت نفسي ألا ترى بأن قصائد الديوان ذات إيقاع منسجم يجذبه مغناطيس العنوان: “كتاب الحب”! وأردفت أن إيقاعها الداخلي يتصاعد بوتيرة واحدة مع إيقاعها الخارجي، وفق موسيقى وخيال محكم.
والحق أن كل قصيدة في الديوان تحتاج إلى قراءات عدة، فكل قصيدة تفتح أفقاً جديداً أمام قارئها، كما تفتح حلماً جديداً وأملاً جديداً.. لننظر إلى قصيدة “قليل من الحب يكفي”، أراها مكتملة تماماً كباقي أخواتها، وبرقها لا حدود لشروده:
“كان يعرف المتقاتلون
أن قليلاً من الحب يكفي
ليغسل ما أبقت الحرب في أرضنا
من دماء القصائد
يغسل حزن المحبين
ممن ذوى ورد أعمارهم
والحبيب يماطلهم وصله” (ص144).
إنها لحظة استدراك لحرب نشبت.. حرب كان بالإمكان استبدالها بقليل من الحب، لكنها -ويا للأسف الشديد- وقعت.
ومثل هذه القصيدة “قصيدة العمر” التي كتبت يوم 23 مايو 1990م، بعد توقيع إعلان الوحدة اليمنية بيوم واحد، فلم تكن تلك اللحظة في نظر الشاعر سوى لحظة حب تختزل العمر بأكمله:
“كنت في شغف أترقبها أن تجيء
-قصيدة عمري-
على شفق اللازورد
وساعة فاجأتني بحضورك
أدركت أنّك أنت التي انتظر القلب.. أنك أنت.. القصيدة” (ص38).
“كتاب الحب” للشاعر السبعيني عبدالعزيز المقالح، ليس مذكرة؛ أو بطاقة تعريف، ليس دستوراً للمحبين، ولا عقداً بين اثنين. إنه مزيج من المشاعر الإنسانية العميقة المشاعر، المأخوذة من كل كواكب السماء من كل بيوت الأرض.. كتاب يحمل في طياته ملايين الأسماء، واللغات، لكنه في النهاية يترك تأثير لغة واحدة.